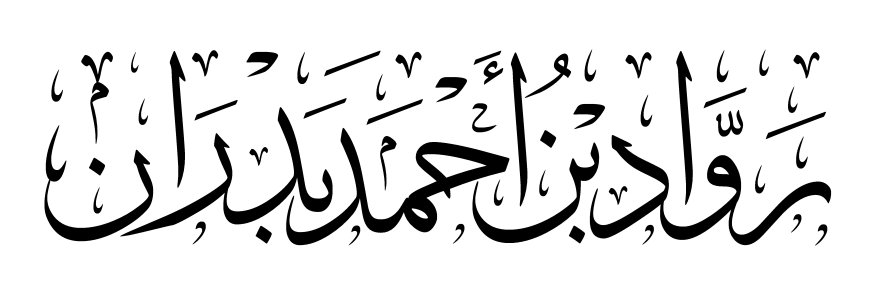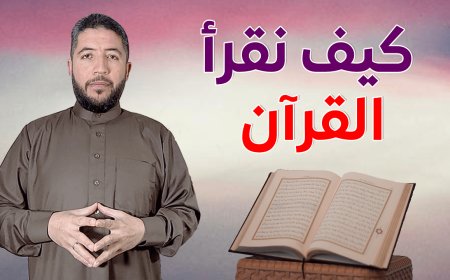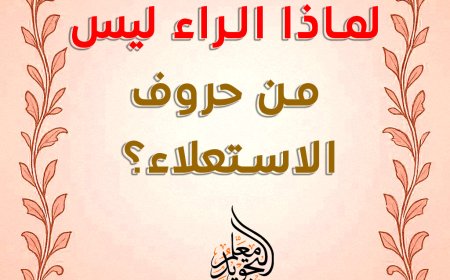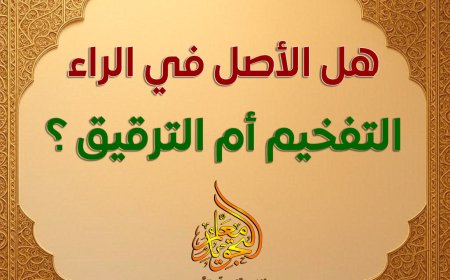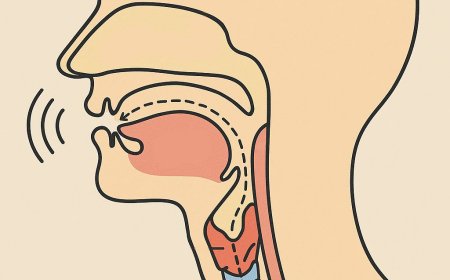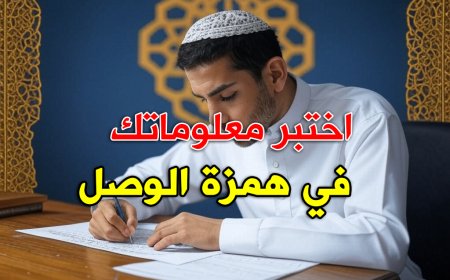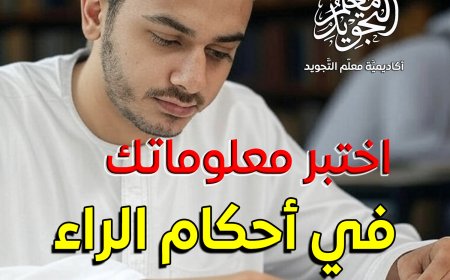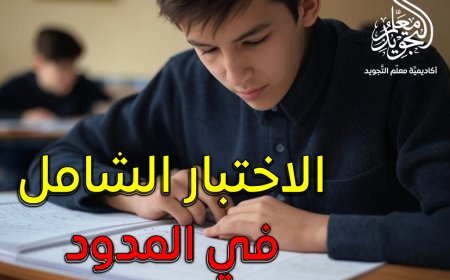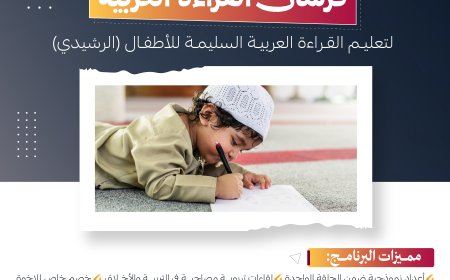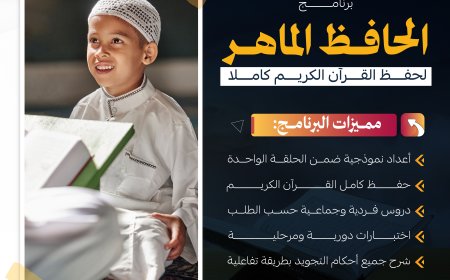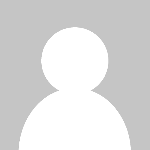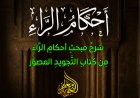أفضل شرح لجميع أحكام الراء من كتاب التجويد المصور حصريا على موقع معلم التجويد
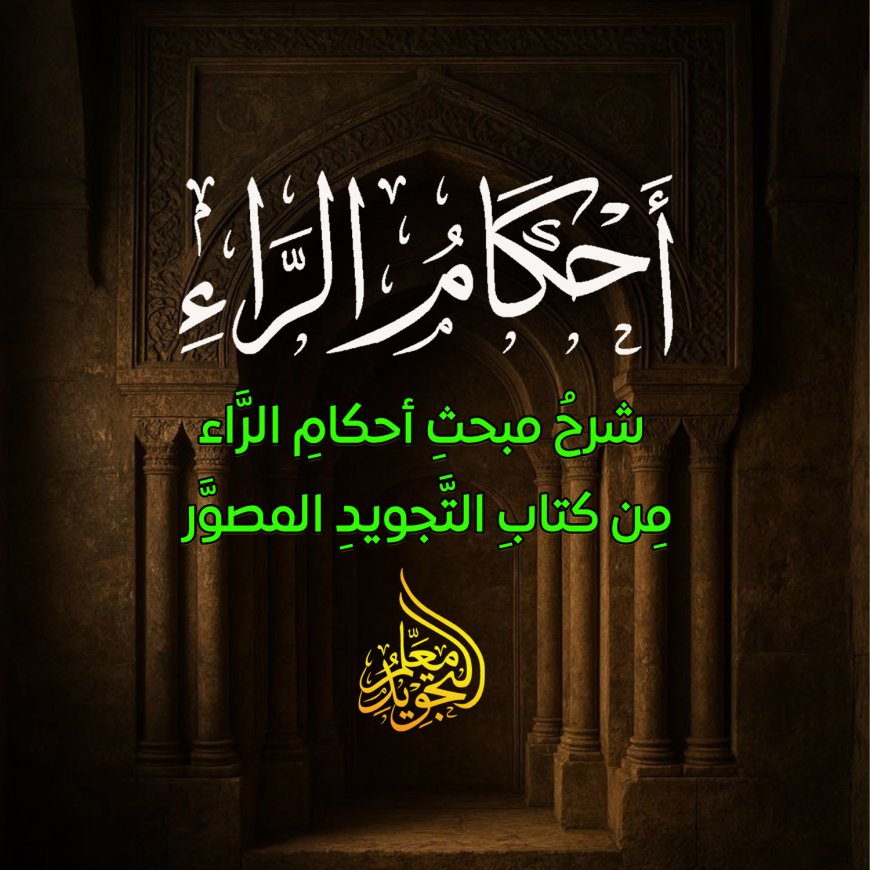
شرحُ مبحثِ أحكامِ الرَّاء مِن كتابِ التَّجويدِ المصوَّر
متى تُفخَّمُ الرَّاء ومتى تُرقَّقُ ومتى يجوزُ فيها الوجهان؟
في هذه المقالة سنتحدَّثُ عن أحكامِ الرَّاء بالتفصيل وسنشرحُها كما ورَدت في كتاب التجويد المصوَّر لفضيلة الدكتور أيمن رُشدي سُويد حفظه الله، فكما هو معلوم فإن كتاب التجويد المصوَّر يُعتبر من أفضل الكتب في علم التجويد في عصرنا الحالي إن لم يكن أفضلَها، وقد تفرَّد هذا الكتاب بتحقيق عدد كبير من مسائل علم التجويد وقدَّمَها بطريقة فنِّيَّةٍ رائعة، ويُعتبرُ مبحث أحكام الرَّاء من أهمِّ المباحث التجويدية التي ناقشها الكتاب بعناية فائقة وبعبارات علميةٍ بالغةِ الدِّقة.
في هذه المقالة سنُوضحُ عبارات كتاب التجويد المصور، وسنفكُّ رموزَها، وسنشرحُ دِلالاتِها بالتفصيل لنصلَ إلى فهمٍ أعمقَ لمبحث أحكام الرَّاء على رواية حفصٍ عن عاصم.
كما هو معلوم فإن للرَّاء ثلاثة أحكام هي: التَّفخيم والتَّرقيق وجوازُ الوجهين، فتُفخَّمُ في (8) حالات، وتُرقَّقُ في (4) حالات، ويجوزُ الوجهان في (2) حالتين، وقبل الانطلاقِ إلى تفصيل هذه الحالات لا بدَّ من التنويه إلى قاعدة جوهرية مهمة تُعتبر أساسًا في فهم أحكام الرَّاء وهذه القاعدةُ تنُصُّ على أن (الفتحةَ والضمةَ هما أساسُ حالات التَّفخيم، أما الكسرةُ فهي أساسُ حالات التَّرقيق)، وانطلاقا من هذه القاعدة المهمة سنَشرَع في تفصيل أحكام الرَّاء.
أولا: حالات تفخيم الرَّاء:
الحالة الأولى: تُفخَّمُ الرَّاء إذا كانت مفتوحة، نحو: (رَمَضَانَ).
الحالة الثانية: تُفخَّمُ الرَّاء إذا كانت ساكنةً وقبلَها مفتوح، نحو: (مَرْيَمَ).
الحالة الثالثة: إذا سكنت الرَّاء وقبلَها ساكنٌ غيرُ ياء، وقبلَه مفتوح، نحو: (وَالْعَصْرْ).
فمن خلال المثال نلاحظ أن الرَّاء سكنتْ بسبب الوقف وقبلَها ساكنٌ وهو الصاد وقبلَه مفتوح فحكمُها التَّفخيم، أما إن سكنتِ الرَّاء وسُبقت بياء ساكنة فحكمُها التَّرقيق، مثل كلمة (خَيْرْ)، كما سيمر معنا بعد قليل من حالات التَّرقيق.
الحالة الرابعة: إذا كانت الرَّاء مضمومة، نحو (كَفَرُواْ).
الحالة الخامسة: إذا سكنت الرَّاء وقبلَها مضموم، نحو: (الْقُرْآنُ).
الحالة السادسة: إذا سكنت الرَّاء وقبلَها ساكن وقبلَه مضموم، نحو: (خُسْرْ).
الحالة السابعة: إذا كانت الرَّاء ساكنة وقبلَها كسرة عارضة، ملفوظةٌ أو مقدَّرة، نحو: (اِرْجِعُواْ)، (الَّذِي ارْتَضَى).
في هذا الحالة لا بدَّ من بيانِ الفرق بين الكسرة الأصلية والكسرة العارضة، وكذلك لا بدَّ من بيان معنى أن تكون الكسرةُ العارضةُ ملفوظةً أو مقدَّرة.
فالكسرة الأصلية تكون ثابتة دائما، مثلَ كسرة الفاء من كلمة (فِرْعَوْنَ) حيث نجدُها ثابتة وصلًا ووقفا، أما الكسرةُ العارضةُ فليست ثابتة دائما إنما تَظهرُ عند الابتداءِ بهمزة الوصل، مثل: (اِرْجِعُواْ)، (الَّذِي ارْتَضَى)، فإذا وصلنا الكلام تَسقطُ همزة الوصلِ وتَسقطُ معها الكسرةُ العارضة، وأيضا نلاحظ أن الكسرةَ العارضة يُمكن أن تكونَ ملفوظة ويمكن أن تكون مقدرة، فالكسرة العارضة (الملفوظة) هي التي تُنطق في بَدءِ الكلام كما هو الحال عند البدء بهمزةِ الوصل كما في: (اِرْجِعُواْ)، (اِرْكَبُواْ) وغيرِها، أما الكسرة العارضة (المقدَّرة) فهي التي لا تُنطقُ لأن همزة الوصل تَسقطُ في دَرْجِ الكلام كما في: (الَّذِي ارْتَضَى).
فالمقصود حقيقة ليس الكسرةُ بحد ذاتِها إنما همزةُ الوصل، فإن ابتدأنا بها تكون الكسرةُ ملفوظة، وإن سَقطتْ همزة الوصل في دَرْجِ الكلام تكون الكسرةُ مقدرة، وفي كلتا الحالتين الرَّاء مفخَّمة.
وهنا قد يسأل سائل: مثلا عند البدء بالفعل: (اِرْجِعُواْ)، فإن الرَّاء تكون ساكنةً وقبلَها كسرةٌ فلماذا لم نُرقِّقِ الرَّاء؟ أليست في النهاية كسرة؟ فلماذا لم تُسبِّب التَّرقيق للراء؟ لماذا هذا التمْييزُ بين الكسرة الأصلية والكسرة العارضة؟
الجواب: الأصل في الرَّاء التَّفخيمُ، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وذلك على اعتبارِ أن حالات التَّفخيم هي أكثرُ من حالات التَّرقيق، ولا تَخرجُ الرَّاء من التَّفخيم إلى التَّرقيق إلا بسبب الكسرة، فإن كانت الكسرةُ أصليةً تُرقَّقُ الرَّاء كما في (فِرْعَوْنَ)، وإن كانت الكسرة عارضةً تبقى الرَّاء على أصلِها من التَّفخيم، والسبب هو أن الكسرةَ العارضةَ ضعيفةٌ ولا تقوى على ترقيقِ الرَّاء.
وفي الحقيقة يمكن أن نُعبِّر عن هذه الحالة بكلمات بسيطة وسهلة فنقول: تُفخَّمُ الرَّاء إذا كانت ساكنة وسُبقت بهمزة وصل، وهذه عبارة صحيحةٌ تناسبُ المبتدئين وتوفِّرُ على المعلمين عناءَ شرحِ المقصودِ بالكسرة العارضة الملفوظة والمقدرة لصغار الطَّلبة، لكن من أرادَ الدِّقَّةَ العلميةَ فلْيستخدِم عبارةَ الكتاب.
الحالة الثامنة: إذا كانت ساكنة وقبلَها مكسور وبعدَها حرف استعلاءٍ غيرِ مكسور في الكلمة نفسِها نحو: (وَإِرْصَادًا)، (قِرْطَاسٍ)، (فِرْقَةٌ).
إذا نظرنا إلى الرَّاء في جميعِ هذه الأمثلة نجد أنها ساكنة، لكن يَتنازعُ عليها سببان متعاكسان، فالكسرةُ قبلَها تريدُ أخذَها باتجاه التَّرقيق وحرفُ الاستعلاءِ غيرِ المكسورِ بعدَها يريدُ أخذَها باتجاه التَّفخيم، ولو وضعنا هذين السببينِ في كفَّتَي ميزانٍ فإن كفَّةَ حرفِ الاستعلاء ستكون بالتأكيد هي الرَّاجحةُ لأنه هو السببُ الأقوى وبالتالي تكون الرَّاء مفخَّمة.
لكن في هذه الحالة مازال هناك عبارةٌ بحاجةٍ إلى توضيح حيث قال المؤلف: "وبعدَها حرفُ استعلاءٍ غيرِ مكسورٍ في الكلمة نفسِها"، ألا يكفي أن يقول: وبعدَها حرف استعلاءٍ فقط دون تحديد الحركة؟ ثم إنه لو قال: وبعدَها حرفُ استعلاء مفتوح، ألا ينطبقُ هذا على هذه الكلمات الخمس (وَإِرْصَادًا)، (قِرْطَاسٍ)، (فِرْقَةٌ)، (مِرْصَادًا)، (لَبِالْمِرْصَادِ)؟ وأخيرا لماذا قال: "في الكلمة نفسِها"؟
في الحقيقة عندما قال في التعريف: وبعدَها حرف استعلاء غيرِ مكسور استثنى حالة واحدة وأَدخلَ حالات أخرى، فالحالة التي استثناها هي أن تكون الرَّاء ساكنة وبعدَها حرف استعلاء مكسور وهذا ينطبق على كلمة واحدة في القرآن الكريم هي كلمة (فِرْقٍ كَالطَّودِ الْعَظِيمِ) وهذه الرَّاء يجوز فيها الوجهان في الوصل.
وأما الحالات التي اندرجَتْ تحت قوله (وبعدَها حرف استعلاءٍ غيرِ مكسور)، فهي أن يكون بعد الرَّاء حرفُ استعلاءٍ مضمومٍ أو ساكنٍ أو مفتوح.
فأما أن تكون الرَّاء ساكنةً وقبلَها مكسور وبعدَها حرف استعلاءٍ مضموم فهذا غير موجودٍ في القرآن الكريم.
وأما أن يكون بعد الرَّاء حرف استعلاءٍ ساكنٍ فهذا ينطبقُ عند الوقف على كلمة واحدة فقط هي كلمة (فِرْقٍ) وفي هذه الحالة حكمُها التَّفخيم.
أو أن يكونَ بعد الرَّاء حرف استعلاءٍ مفتوح وهذا ينطبقُ على الكلمات الخمس (وَإِرْصَادًا)، (قِرْطَاسٍ)، (فِرْقَةٌ)، (مِرْصَادًا)، (لَبِالْمِرْصَادِ)، ولكن كي تنطبق القاعدة على هذه الكلمات تماما أضاف قيدًا آخرَ وهو أن يكون حرف الاستعلاء في الكلمة نفسِها، والسبب هو أنه بالفعل توجدُ كلماتٌ في القرآن الكريم تكون فيها الرَّاء ساكنةً وقبلَها مكسور وبعدَها حرف استعلاءٍ غيرُ مكسور لكن في الكلمة التالية، كما في قوله تعالى (أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ) (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ) (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) ولا يوجَد غيرُها في القرآن الكريم، والرَّاء في جميع هذه الأمثلة مرقَّقة.
إذا في المحصلة: تُفخَّمُ الرَّاء إذا كانت ساكنةً وقبلَها مكسور وبعدَها حرف استعلاء غيرِ مكسور في الكلمة نفسِها، وهذه العبارة دقيقة جدًّا بحيث تنطبقُ تماما على الكلمات المطلوبة وهي (6) كلمات وتُخرجُ ما عداها، وهذه الكلمات هي (فِرْقْ) عند الوقف عليها بالسكون، بالإضافة إلى الكلمات الخمس (وَإِرْصَادًا)، (قِرْطَاسٍ)، (فِرْقَةٌ)، (مِرْصَادًا)، (لَبِالْمِرْصَادِ)، وبهذا ينتهي الكلام على حالات تفخيم الرَّاء.
ثانيا: حالات ترقيق الرَّاء:
تُرقَّقُ الرَّاء في (4) حالات وكلها مرتبطةٌ بالكسرة.
الحالة الأولى: تُرقَّقُ الرَّاء إذا كانت مكسورة، نحو (كَرِيمٍ) (رِيحٌ).
الحالة الثانية: تُرقَّقُ الرَّاء إذا كانت ساكنة وقبلَها كسرة أصلية وليس بعدَها حرف استعلاء، نحو (فِرْعَوْنَ).
فإن سكنت الرَّاء وسُبقت بكسرة عارضة تُفخَّمُ، مثل (اِرْجِعُواْ) كما مر في الحالة السابعة من حالات التَّفخيم.
وإن كان بعدَها حرف استعلاء غيرِ مكسور تُفخَّمُ أيضا، مثل (قِرْطَاسٍ) كما درسنا قبل قليل في الحالة الثامنة من حالات التَّفخيم.
الحالة الثالثة: تُرقَّقُ الرَّاء إن كانت ساكنة وقبلَها ساكن غيرُ مُستَعْلٍ وقبلَه مكسور، مثل (حِجْرْ) (قَدِيرْ).
فإن سكنتِ الرَّاء وسُبقت بحرف استعلاء ساكن وقبلَه مكسور جاز فيها الوجهان كما سنرى بعد قليل من حالات جوازِ الوجهين في كلمتي (مِصْرْ) و(الْقِطْرْ).
الحالة الرابعة: إذا سكنتِ الرَّاء وسُبقت بياءِ لِين، نحو (خَيْرْ) (لَا ضَيْرْ).
وهنا لا بدَّ إن نقف وِقفتين عند هذه الحالة.
الوقفة الأولى: أن البعضَ يقول عن الرَّاء في كلمة (خَيْرْ) أنها يجب أن تكون مفخمةً لأنها ساكنة وقبلَها ساكن وقبلَه مفتوح، وهذا الكلامُ غيرُ صحيح والسبب هو أن الرَّاء سكنتْ وسُبقت بحرفٍ ساكنٍ مميَّزٍ هو الياء، وهذا الحرف ليس حرفا عاديًّا، إن الياء هي أُمُّ الكسرةِ وبالتالي نُرقِّقُ الرَّاء عند الوقف على كلمة (خَيْرْ) وما شابهها، علمًا أننا قبل قليل رقَّقْنا الرَّاء في كلمة (فِرْعَوْنَ) لأنها سكنت وسُبقت بكسرة فكيف إذا سَكنتْ وسُبقت بأمِّ الكسرة فمن بابِ أَولى أن تكونَ مرقَّقة.
الوقفة الثانية: هل يصحُّ أن نقول تُرقَّقُ الرَّاء إذا كانت ساكنة وقبلَها ياءٌ ساكنة فنشمَل بهذا الكلامِ الياءَ المدِّيَّةَ كما في (قَدِيرْ) والياءَ اللِّينِيَّةَ كما في (خَيْرْ)؟
الجواب: هذا الكلام صحيح ولكنه ليس دقيقًا تماما لأن الياءَ إن كانت مدِّيَّةً كما في كلمة (قَدِيرْ) فإنها تندرجُ تحت الحالةِ الثالثة حيث الرَّاءُ ساكنةٌ وقبلها ساكنٌ غيرُ مستعلٍ وقبلَه مكسور، أما إن كانت الياءُ لينيةً فإنها تندرج تحت الحالة الأخيرة، لكن إذا أردنا تبسيطَ الموضوع على الطلاب فيكفي أن نقول لهم أن الرَّاء تُرقَّقُ إن كانت ساكنةً وسُبقت بياءٍ ساكنة، مثل (قَدِيرْ) (لَا ضَيْرْ)، ولكن إن أردنا الدِّقَّةَ العلميةَ فإننا نستخدمُ عبارةَ الكتاب، وبهذا ينتهي الحديث عن حالات التَّرقيق الأربع.
ثالثا: حالات جواز التَّفخيم والتَّرقيق في الرَّاء:
في هذا القسم من أحكام الرَّاء لدينا حالتان تتعلقان بثلاثِ كلمات فقط هي (فِرْقٍ) (مِصْرَ) (اَلْقِطْرِ)، ففي كلمة (فِرْقٍ) يجوزُ الوجهان في الرَّاء في حالة الوصل، أما في كلمتي (مِصْرَ) (اَلْقِطْرِ) فيجوزُ الوجهان في حالةِ الوقف، وفيما يلي بيانُ هاتين الحالتين بالتفصيل.
الحالة الأولى: يجوزُ التَّفخيم والتَّرقيق في الرَّاء إذا كانت ساكنة وقبلَها مكسور وبعدَها حرف استعلاءٍ مكسور وذلك حالة الوصلِ أو الوقفِ بالرَّوْمِ على قوله تعالى (فِرْقٍ كَالطَّوْدِ).
فإذا وصلنا كلمة (فِرْقٍ) بما بعدَها جاز لنا التَّفخيمُ والتَّرقيق في الرَّاء، وكذلك إن وقفنا بالرَّوْمِ أي ببعضِ الكسرة فإنه يجوزُ لنا الوجهان أيضا لأن الرَّوْمَ حكمُه حكمُ الوصل.
وسبب جوازِ الوجهين في هذه الكلمة هو أن الرَّاءَ ساكنةٌ وقبلَها مكسور وهذا سبب يأخذُها باتجاه التَّرقيق، لكنْ جاء بعدَها حرف استعلاء وهذا سبب يأخذُها باتجاه التَّفخيم، فمن نظرَ إلى حرف الاستعلاء ولم يَعْتَدَّ بكسرتِه قال بوجهِ التَّفخيم، وبهذا يكون قد جعلَها مع الحالة الثامنة من حالات التَّفخيم أي مع كلمة (قِرْطَاسٍ) وأخواتِها، وأما من نظرَ إلى حركة حرفِ الاستعلاءِ وأنه صارَ ضعيفًا بسببِ الكسرة قال بوجهِ التَّرقيق وصلا أو عند الوقف بالرَّوْمِ كما ذكرنا قبل قليل، علمًا أن كلا الوجهينِ متساويان في القوة فمن شاء قرأ بالتَّفخيم ومن شاء قرأ بالتَّرقيق.
أما عند الوقفِ على كلمة (فِرْقْ) بالسكون ففي الرَّاء التَّفخيمُ لا غيرَ لزوالِ مُوجِبِ التَّرقيق وهو كَسرُ حرف الاستعلاء (القاف)، فسبب جواز الوجهين في هذه الكلمة هو كَسرُ حرف الاستعلاء كما قال الإمام ابن الجزري: وَالْخُلْفُ في فِرْقٍ لِكَسْرٍ يُوجَدُ، أي في حرفِ القاف، فإذا وقفنا بالسكونِ فإن الكسرَ يزولُ عن القافِ ويصبحُ ساكنًا، وبالتالي سيرتقي ويَصعدُ من أدنى مراتبِ التَّفخيم وهي المرتبة الخامسة، إلى المرتبة الرابعة والتي هي للساكن، وبهذا تزدادُ قوَّةُ القافِ أكثرَ مما يسبب التَّفخيم للراء، فكلمة فرق في حالة الوقف عليها بالسكون تنطبقُ عليها تماما الحالة الثامنة من حالات التَّفخيم.
الحالة الثانية: إذا سكنت الرَّاء وقبلَها حرف استعلاءٍ ساكن وقبلَه مكسور وذلك عند الوقف بالسكون على كلمة (مِصْرْ) (القِطْرْ).
فمن قال بوجه التَّرقيق نظرَ إلى الكسرة مباشرة واعتبرَ حرفَ الاستعلاءِ حرفًا عاديًّا مثلَه مثل أي حرف تماما كما هو الحال عند الوقف بالسكون على كلمة (حِجْرْ)، أما من قال بوجهِ التَّفخيم فقد نظرَ إلى حرف الاستعلاء واعتبره حاجزا قويًّا يَفصلُ بين الرَّاء وبين الكسرة، فهذا هو تفسيرُ سبب جواز الوجهين في هاتين الكلمتين، لكن هل يوجد وجه أقوى من وجه؟ في الحقيقة كلا الوجهين متساويان في القوَّةِ ولا يوجد وجهٌ أرجحُ من الآخر، فمن شاء وقف بالتَّفخيم ومن شاء وقف بالتَّرقيق، إلا أن الإمام ابن الجزريِّ اختارَ التَّفخيمَ في (مِصْرْ) والتَّرقيقَ في (اَلْقِطْرْ) مراعاةً للوصل، أما في حالة الوصل فالرَّاء مفخمة في (مِصْرَ) لأنها مفتوحة، ومرققة في (اَلْقِطْرِ) لأنها مكسورة، علمًا أن اختيارَ الإمامِ ابن الجزريِّ ليس مُلزِمًا لأنه اجتهاد منه – رحمه الله - فمن أراد أن يقلِّدهُ فلا بأس، ومن أراد أن يقرأ بالوجهين فلا بأس.
وبهذا نكون قد أنهينا الكلامَ على أحكام الرَّاء من كتاب التجويد المصوِّر فشرحنا حالات التَّفخيم الثماني، وحالات التَّرقيق الأربع، وأخيرا حالتا جواز الوجهين، ولمزيد من التفصيل والإيضاح ولمن أراد الاستماعَ للأداء العملي لجميع هذه الحالات فيمكنكم مشاهدةُ هذه الحلقة الخاصَّةِ من برنامج: الشرحُ الميسَّر لمنظومة المقدِّمة الجزريَّة مع كتاب التجويد المصور والتي عُرضت على قناة معلم التجويد، يمكنكم المشاهدة من >>> (هنــا) <<<
والحمد لله رب العالمين
كتبه خادم القرآن الكريم: